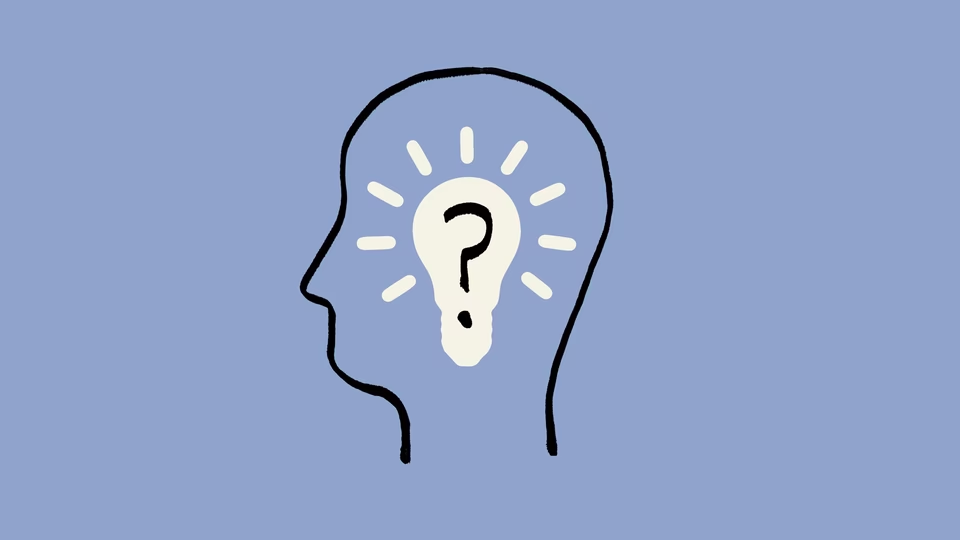ولذلك فإن المطلوب في العلم الشرعي – والعقدي خصوصاً – أوسع من مجرد الوقوف على هذه النقول، بل يستلزم معرفة الأدلة التفصيلية، والإحاطة بمسالك المخالفين والرد عليهم، وتوسيع البنيان العقدي بقراءة ما سطره المحققون من أهل السنة في تقرير عقيدة السلف والانتصار لها، كما في مصنفات الأئمة الكبار أمثال ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ثم العودة إلى تهذيب النفس بهذه العلوم وإصلاح القلب والعمل. على أنّ ما تضمنته هذه الكتب من نبذ العقيدة ليس مما يخفى على عوام المسلمين الذين نشؤوا على الفطرة السليمة، فكيف يليق بطالب علم أن تكون غاية جهده معرفة ما هو في متناول العامة، بينما يزهد فيما وراءه من المعارف العظيمة؟
ومن يتجاوز النظر في حال هؤلاء يجد أنهم ضعفاء العناية بأهم دواوين الإسلام وهي الكتب الستة التي تمثل عمدة الحديث النبوي، فلا يعرفون منها إلا بعض الأبواب المشتركة مع مباحث عقدية محدودة، وقد فاتهم بحر السنن الواسع الذي لا غنى لطالب علم عنه. وهذا تقصير خطير، إذ إنّ السنّة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع، ولا قيام لمنهج سلفي صحيح إلا بالرسوخ فيها، وقد قرر الإمام الشافعي أنّ كل نازلةٍ تنزل بأهل الإسلام ففي كتاب الله أصلها، وفي سنّة رسوله البيان لها (الرسالة، ص/20). وإذا فات المرء هذا المورد النبوي الرويّ فقد خسر كثيراً وضاع عليه عظيم.
وأمّا الفقه، فقد صار عندهم خارج دائرة الاهتمام، إلّا ما يقتبسونه من "الفتاوى الجاهزة" أو ما يسمّونه "القول الراجح" دون نظرٍ وتأصيل أو ممارسة علمية حقيقية تقوم على استقراء كلام الفقهاء وأدلتهم. وهذا يورث فقراً في الفهم، ويجعل صاحبه أسيراً لسطحية القول دون رسوخٍ في النظر. وأما علم أصول الفقه، فهو عندهم مهجور تماماً، بل يُزدرى أحياناً، مع أنّه ميزان الاجتهاد وضابط الاستدلال، وقد كان السلف الكبار من أوائل من أسس قواعده، حتى صنّف الشافعي الرسالة لتأصيل مناهج الاستنباط. ومن عجب أن يزعم هؤلاء الانتساب إلى السلفية وهم في موقفهم من الأصول أبعد ما يكونون عن صنيع السلف.
وقد انعكس هذا الخلل المنهجي على خطابهم الدعوي، فصار يغلب عليه جانب الإقصاء والتبديع، مع عجزٍ عن تقديم بدائل علمية رصينة أو معالجات واقعية متوازنة. وهنا يظهر أثر ما حذر منه ابن القيم بقوله: "وفسادٌ عظيم يدخل على العبد من جهتين: إحداهما فساد العلم، والثانية فساد العمل" (إعلام الموقعين، 1/72). فحين يرضى طالب العلم بالجهل ويتباهى به، فقد رضي لنفسه بالحرمان من نور العلم، وزاد على ذلك أن جعل الجهل منهجاً يتفاخر به.
وهكذا فإن الاقتصار على بعض نصوص العقيدة، وإغفال السنن والفقه والأصول، وتقديم الجدل على التربية، والتبديع على التحقيق، إنما هو مظهر صارخ لأزمة التكوين العلمي عند بعض المنتسبين إلى السلفية. ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة إلا بالعودة إلى الجمع بين علوم الشريعة كلها في تكاملها، على نهج الأئمة المحققين كابن تيمية وابن القيم والذهبي والغزالي والنووي وابن حجر وغيرهم كثير، مع تهذيب النفس وتزكيتها، حتى يكون طالب العلم صادق الانتساب إلى السلف، بالعلم والعمل والسمت والسلوك، لا بمجرد دعوى أو شعار.
منار الدين الدقر
منار الدين الدقر، باحث وأكاديمي سوري، ومشارك في الثورة السورية منذ انطلاقتها الأولى، أحمل في قلبي قضايا وطني، وفي فكري هموم أمتي، وأسعى أن أجمع بين العمق العلمي، والنضج الفكري، والخبرة الميدانية، بروح ثائرة لا تنكسر، وبعقل ناقد باحث. خلال أكثر من عقد من العمل، مزجت بين التحصيل الشرعي، والتأهيل الأكاديمي المتعدد، والخبرة الإدارية والتربوية، والمسؤولية المجتمعية، في محاولة لبناء مشروع معرفي تربوي يكون امتدادًا لقيم الثورة، وأصالة العلم، وإنسانية الرسالة.